- الثلاثاء، ٢٧ يناير ٢٠٢٦
- إتصل بنا
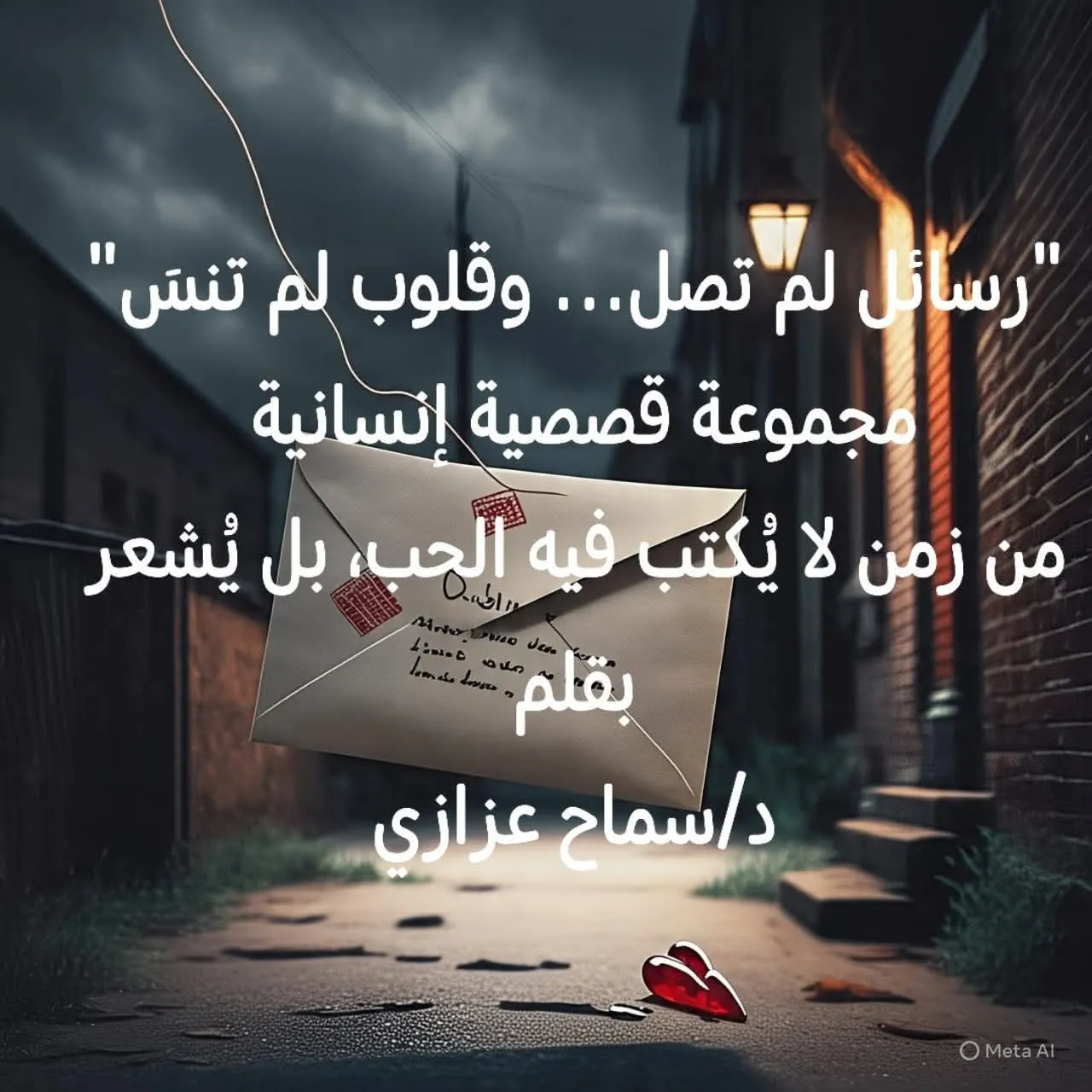
بقلم د/ سماح عزازي
عن الذكرى حين تسكن شيئًا صغيرًا… ويصير كل ما تبقى من الحب.
ليس كلُّ شيءٍ صغيرٍ في حجمه… صغيرًا في أثره.
فهناك أشياء تُشبهنا أكثر مما يشبهنا البشر… أشياء تلمسُ القلب في عمقه، وتحتفظ بأسرارنا دون أن تُفشيها، تسمعنا حين نصمت، وتبكينا حين نلمسها.
وهكذا كانت علبة الموسيقى…
في ركنٍ هادئ من بيتٍ قديم، حيث الغبار يُغطي الذكرى، وحيث الزمن يمرّ دون أن يُوقظ قلبًا غافياً… كانت علبة صغيرة من خشبٍ مطعّم، تقف كجندي قديم في متحف الحنين، لا تصرخ، لا تتحرّك، لكنها تحفظ في جوفها صوتًا واحدًا: نغمة، لا تتغيّر، لا تكذب، لا تنسى.
في زمنٍ صار فيه الحُبّ يُكتب بالأصابع الباردة، ويُقال كواجبٍ يومي، كانت تلك العلبة تحفظ ذاكرة امرأة… عاشت حبًا نقيًّا، وانكسر فيها الزمن بعد رحيل صاحبه.
لم تكن تفتحها دائمًا… كانت تخاف من صوتها، تخاف من أن يعود الماضي بصوته، بصورة يديه، بعطره الخفيّ الذي سكن النغمات، وتخاف أن تُنكأ الندبة التي تعايشت معها كجزءٍ منها.
في تلك العلبة… لم تكن الموسيقى هي البطلة، بل كان القلب هو الذي يدور كلما دارت النغمة، وتنكشف خيوط الذاكرة مع كل لفةٍ من مفتاحٍ صغير… لفة تشبه لفّات القدر.
هذه قصة امرأة لم تودّع… بل اختبأت.
لم تُكمل الحكاية، بل حبستها في صندوق، وارتدت ابتسامة العابرين… بينما كانت تعيش كل شيء من جديد، كلما سمعت لحنه.
لم تكن تفتح العلبة كثيرًا…
كانت فقط تمرّر يدها على سطحها الخشبي الناعم،
كأنها تخشى أن تؤلمها النغمة، أو أن يوقظها الحنين.
علبة موسيقى صغيرة، مستطيلة، بنقوش ذهبية باهتة…
ورغم بساطتها، كانت أكثر الأشياء ثمنًا، لأنها الشيء الوحيد الذي تبقّى منه.
منذ رحيله، لم يترك لها شيئًا سوى تلك العلبة…
أهداها إياها ذات يوم وقال:
"حين أكون بعيدًا، افتحيها… ستسمعينني."
لم تكن تفهم ما قصد وقتها،
لكنها اليوم… تفهم كل شيء.
فكلما أدارت المفتاح الصغير…
دارت معها الذاكرة، ودار الوجع، ودارت صورتُه في ذهنها، كما لو كانت الموسيقى تنفض الغبار عن قلبها.
لم تكن النغمة مجرد لحن،
بل موعدًا صغيرًا بين قلبين افترقا،
وصوتًا يقول في الخفاء:
"أنا لم أغب تمامًا… فقط غيّرنا الزمان."
مرت السنوات…
صار للبيت صوت الصمت،
وصار قلبها يختبئ في أشياء صغيرة:
فنجان قهوة لم تُبدّله، منديل منسدل على حافة الكرسي،
وصندوق موسيقى… لا تفتحه إلا حين تشتاق حتى تكاد تختنق.
لم يكن أحد يفهم ما تفعل.
يظنون أنها امرأة عتيقة، تعيش في الماضي،
لكن لا أحد كان يسمع ما تسمعه…
ولا أحد كان يعلم أن داخل تلك العلبة الصغيرة،
يسكن قلب، وذكرى، ووعدٌ لم يُكمل طريقه.
وفي إحدى الليالي، جلست في العتمة، وحدها،
وفتحت العلبة.
صدر اللحن كما لو كان أول مرة،
رقيقًا… مرتجفًا…
كأن النغمات تخاف أن تجرحها.
كانت علبة الموسيقى، بالنسبة للعالم، مجرد تذكار خشبي جميل…
لكن بالنسبة لها، كانت نافذة تُفتح على زمنٍ لا يعود،
تُطل منها على قلبٍ لم يعد له وجود، إلا في النغم…
ذلك النغم الذي لا يتغير، لا يشيخ، لا يخون.
كم من مرة أمسكت العلبة ثم ترددت؟
خافت أن تدير المفتاح، ليس لأنها لا تريد سماع الصوت،
بل لأنها تعرف أن بعد النغمة… سيأتي الصمت،
وأن لحظة اللقاء تنتهي دائمًا بلحظة الغياب.
هي لا تبحث عن لحن… بل عن قلب.
عن عناق قديم يتسلل من بين النغمات،
عن كلمة "اشتقتُ إليكِ" التي لم تُقال، لكنها كانت تُسمع في عينَيه.
وكلما اشتدّ بها الحنين،
جلست في نفس الزاوية التي اعتاد الجلوس فيها،
وأدارت المفتاح… برعشة أصابع فقدت يقينها.
كانت النغمة تبدأ خجولة… كما كان يبدأ حديثه معها،
ثم تتصاعد… كأنها ضحكته، كأنها دفء يده، كأنها هو…
وحين تصل الذروة،
تشعر أن قلبها لم يعد قادرًا على التحمّل،
فتهمس، ببقايا صوتها:
"ما زلتَ تعيش هنا… في النغمة، وفي الذاكرة، وفي نبضي."
وضعت يدها على صدرها،
وبكت بصمت… كما تفعل منذ سنوات.
ثم همست:
"أنا هنا… ولم أنسَ.
وما زالت الموسيقى، يا حبيبي… تحفظ صوتك، حتى لو نسيت الدنيا كلها."
انتهى اللحن… لكن الدموع لم تنتهِ.
أغلقت العلبة برفق، وقبّلت سطحها الخشبي كأنها تودّع شيئًا حيًّا.
ثم أغلقت الضوء.
ورحلت عن الغرفة…
لكن الصوت بقي.
في إحدى الليالي الشتوية، هطل المطر كما لم يفعل من قبل،
وضربت قطراته النوافذ كأنها تنادي على قلبٍ وحيد.
جلست أمام العلبة، لا لتفتحها، بل لتتأملها فقط…
كأنها تتأمل وجهه في مرآة الذكرى.
تساءلت بينها وبين نفسها:
"هل يشتاق الموتى إلينا كما نشتاق إليهم؟
هل يسمعون الموسيقى التي نُشغّلها من أجلهم؟
هل تأتيهم دموعنا، كما تأتينا نغمتهم؟"
كانت تعرف أن لا جواب…
لكنها كانت تؤمن أن الحب — حين يكون صادقًا —
لا يحتاج لأبواب السماء كي يصل،
فهو يعرف طريقه… من القلب إلى القلب، ولو كان في عالمٍ آخر.
أدارت المفتاح أخيرًا، وسالت النغمة في الغرفة كأنها دمعة طويلة،
اختلطت بأنفاسها، بألمها، بحنينها الذي لم يبرُد منذ أن رحل.
وقبل أن تنام، وضعت العلبة قرب سريرها،
كأنها تضع قلبها هناك…
فلا نوم بلا موسيقى، ولا موسيقى بلا ذاكرة،
ولا ذاكرة… بلاه.
كأن الموسيقى قررت أن تعيد نفسها مرة أخيرة،
لأن الحنين أقوى من السكون،
ولأن القلب — حين لا يجد من يسمعه — يخبّئ نفسه…
في علبة موسيقى
رحل الجميع… وبقيت هي.
بقيت تنظر إلى العلبة كما لو أنها نافذةٌ إلى عالمٍ كان لها ذات يوم…
كل ما تبقى من رجفة الحب، ونبض اليد، ونظرة الوداع التي لم تحدث.
وفي كل ليلة، حين ينام البيت، كانت تجلس أمامها، كأنها تتأهب للقاء.
تُدار العلبة، ويبدأ اللحن… فيدور معه الزمن، وتعود هي كما كانت: عاشقة، حبيبة، أنثى نضرة تخبئ قلبها بين الأوتار، وتُرسله إليه عبر الموسيقى.
ولم تكن تلك الموسيقى تخبرها بالحنين فقط…
بل كانت تُطمئنها: أن من أحبّ بصدق، لا يموت بداخله الحُب،
وأن القلب الذي صدق النغمة… سيظل يدقّ حتى بعد أن تتوقف الحياة من حوله.
وفي النهاية… حين تُغلق العلبة، لا ينتهي شيء.
بل تبدأ طقوس الصمت المُقدّس…
ذاك الذي لا يحتاج إلى كلمة، ولا إلى لمسة،
ذاك الذي يقول أكثر مما تجرؤ أن تقوله الحروف.
فالحبُّ الحقيقي، حين لا يجد بيتًا… يسكن الأشياء.
يسكن فنجانًا قديمًا، مقعدًا فارغًا، أو علبة موسيقى…
لا يُراها أحد، لكنها — وحدها — تعرف كل الحكاية.
التعليقات الأخيرة